الفقيه ابن عرضون المفترى عليه
د الميلود كعواس
إن من المسائل التي كثر عنها الحديث بعد الإعلان عن المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة وقبلها؛ مسألة اقتسام الممتلكات الزوجية بعد الوفاة أو الطلاق. وقد حاول بعض الناس الاستناد في نصرة قوله في هذا الموضوع على فتاوى بعض العلماء وأقوالهم؛ لعل أشهرهم ورودا على الألسنة؛ الفقيه ابن عرضونالغماري؛ حيث جعل منه هؤلاء أسطورة، واتخذوا منه بطلا وزعيما، على اعتباره أنه قد أفتى في زمانه باستحقاق المرأة النصف من الممتلكات الزوجية بعد الوفاة أو الطلاق، سواء أشاركت زوجها أم لم تشاركهفي إنماء تلك الممتلكات، بناء على ما اصطلح عليه بين الفقهاء بحق الكد والسعاية.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: ما مدى صحة القول المنسوب إلى هذا الفقيه الغماري؟ وما حيثياته؟ وما قواعده وضوابطه؟
سأحاول الجواب عن هذه الأسئلة وفق العناصر الآتية:
أشير في البدء إلى أن الرجل المشهور ذكره في مسألة الكد والسعاية هو أبو العباس أحمد بن الحسن بن عرضون الزجلي الغماري، وهو من أسرة عربية قرشية الأصول، ولد بمدشر أدلدال، شرقي مدينة شفشاون، سنة: 948هـ/1541م. نشأ في وسط علمي بقرية تلنبوط، حيث كان أبوه خطيبا، ومدرسا بمساجدها، ومن أعيان القبيلة، وإليه يرجع الفضل في تحبيب العلم إليه، وتوجيهه وجهته، حفظ القرآن الكريم، وكثيرا من الأشعار، ثم سارع إلى تلقي مبادئ العلوم عن شيوخ البلد؛ كعبد الله الهبطي، وسليمان بن أبي هلال الملولي… ثم رحل إلى فاس لإتمام دراسته بجامع القرويين، فأخذ عن وجوه الفقهاء، أمثال: محمد القصار، وعبد الله الحميدي، ويحيى السراج، ومحمد بن مجبر المستاري، ورضوان الجنوي، وغيرهم.
ولي بعد رجوعه من فاس قضاء شفشاون، وزاول إلى جانب ذلك مهام متعددة؛ كالخطابة، والتدريس، والإفتاء.
يذكر له المترجمون كتبا عدة أهمها: اللائق لمعلم الوثائق، مسائل ملقوطة من نوازل مازونة، مقنع المحتاج في آداب الزواج، رسالة التوادد والتحاب في آداب الصحبة… توفي رحمه الله بفاس في 10 رجب 992هـ/1584م.
وأنبه إلى أن للفقيه أحمد المذكور أخ يسمى: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عرضون (ت1012هـ)؛ وهو من الذين أفتوا بالكد والسعاية أيضا، غير أنه لم يشتهر كما اشتهر أخوه أحمد، بسبب تحديده لمقدار السعاية في نصف الممتلكات المشتركة، وهو ما لم يشتهر به أحد غيره.
لا أحد يماري بأن فقهاء المغرب؛ وخاصة في غمارة وسوس قد أفتوا بحق الكد والسعاية؛ لكن مقصودهميخالف تماما ما هو رائج عند بعض الناس اليوم؛ وقد تتبعت تعريفات الفقهاء لهذا المفهوم فتبين بأن حق الكد والسعاية يراد به: حق أحد أفراد الأسرة في أخذ نصيب من الثروة التي أسهم في تكوينها، بعد الموت أو الطلاق.
ومن خلال تأمل هذا التعريف المستخلص من كلام الفقهاء تتضح لنا أمور:
إن قواعد البحث العلمي تقتضي إيراد نص فتوى ابن عرضون بتمامه؛ وهو ما يتلافاه بعض الناس؛ بحيث يعمدون إلى تشهير الأقوال من غير أدلة، وإذاعة الفتاوى من غير بينة، كما أنهم يعمدون إلى منهج الاجتزاء وفصل الفتوى عن حيثياتها وتفاصيلها وشروطها، بغية التمكين لقول على حساب آخر، وهذا مخالف لمنطق العلم ولقواعد المعرفة الصحيحة.
وأحب أن أشير في البداية إلى أن فتوى الكد والسعاية فتوى مشهورة قبل ابن عرضون، وقد نقل ذلكالعلمي وغيره، فقال: «سئل أبو عبد الله سيدي محمد بن الحسن بن عرضون عمن تخدم من نساء البوادي خدمة الرجال، من الحصاد، والدراس، وغير ذلك، فهل لهن حق في الزرع بعد وفاة الزوج لأجل خدمتهن، أو ليس إلا الميراث؟
فأجابه بما أجاب به الشيخ القوري؛ مفتي الحضرة الفاسية، وشيخ الإمام ابن غازي. قال: إن الزرع يقسم على رؤوس من نتج عن خدمتهم. زاد عليه مفتي البلاد الغمارية: جدنا سيدي أبو القاسم خجو، على قدر خدمتهم، وبحسبها من اتفاقهم أو تفاوتهم، وزدت أنا –لله عبد- بعد مراعاة الأرض، والبقر، والآلة، فإن كانوا متساوين فيها أيضا فلا كلام، وإن كانت لواحد حسب له ذلك، والله تعالى أعلم».
وهذه الفتوى كما يظهر من نصها محصورة في مكانها؛ فهي متعلقة بمنطقة غمارة، ومتعلقة بمجال محدد هو العمل الفلاحي، وخاصة بالنساء العاملات عمل الرجال في مجال الفلاحة دون غيرهن، كما أن هذه الفتوى تنص على أن الاستحقاق مرتبط بقدرة الإسهام في الإنتاج، فقد يكون المقدار عُشُرا وقد يكون ربعا وقد يكون نصفا أو غير ذلك.
غير أن هذه الفتوى المذكورة غير مقصودة من لدن المتكلمين في الموضوع، وإنما الفتوى التي يروج لها اليوم هي فتوى أحمد بن الحسن بن عرضون؛ أخو محمد المذكور آنفا؛ ذلك أن الرجل نُسب إليه القول بأنه قد حكم للزوجة باستحقاق النصف من المال المكتسب، على خلاف ما أفتى به الفقهاء قبله.
ورغم شهرة هذه الفتوى، وكثرة الاستدلال بها من لدن بعض الناس اليوم؛ فإن البحث الدقيق يفضي بنا إلى القول بأن الفقيه أحمد بن عرضون قد ظلم في هذا الذي يروج، وافتري عليه فيه؛ وبيان ذلك من وجوه:
وبناء على هذا يتبين إن المسلك المعتمد في نقل فتوى أحمد بن عرضون هو الرواية الشفوية؛ ومعلوم ما قد يعتور هذا المسلك من مخاطر التصرف في المنقول بالزيادة أو النقصان، أو الغفلة عن نقل الضوابط والقيود، أو الحيثيات والسياقات، أو الشروط وتوابعها، وغير ذلك مما قد يصيب المنقول بالرواية الشفهية.
ورغم أن بعض المتأخرين قد أشاروا إلى هذه الفتوى في كتبهم بناء على ما سمعوه من الناس شفاها، فقد تحفظوا عن نسبتها للفقيه ابن عرضون احتياطا للدين، وحذرا من الافتيات على الرجل؛ وهذا ما نقله المهدي الوزاني (ت1342هـ) عن العلامة سيدي محمد بن قاسم الفلالي وهو يشرح قول الناظم:
قال ابن عرضون لهن قسمة *** على التساوي بحساب الخدمة
قال: «وبالجملة؛ فقد أجمل الناظم رحمه الله في كلامه غاية، إذ لم يبين العرف الذي اعتبر أهل فاس، ولا القسمة التي قال ابن عرضون، ولا خدمة النساء، هل في زرع الأزواج، أو في زرع غيرهم. وكلام ابن عرضون الذي يمكن أن يتضح به المراد لم أظفر به في “اللائق”، ولعله ذكر ذلك في فتوى صدرت منه أو في مؤلف لم أعلمه». وقد علق المهدي الوزاني، باعتبارهأشد الناس انتصارا لفتوى ابن عرضون، على هذا الكلام، وحاول إثبات عدد من مسائل هذه الفتوى، لكنه لم يستطع إثبات نص فتوى أحمد ابن عرضون الذي يمكن من خلاله حل الإشكال.
وخدمة النساء في البـوادي *** للزرع بـالـدراس والحصـاد
قال ابن عرضون لهن قسمه *** على التساوي بحساب الخدمـه
لكن أهل فاس فيها خالفـوا *** قالوا لهم في ذلك عرف يعرف
فأين الحديث في هذا عن العمل المنزلي ورعايةأفراد الأسرة، الذي يصر هؤلاء الناس إصرارا على نسبة القول في ذلك لابن عرضون؟
وهذا القول المذكور؛ أي تحديد الكد والسعاية بقدر الخدمة، هو قول الفقهاء قاطبة؛ منهم أبو القاسم خجو، وأبو عبد الله محمد بن الحسن عرضون، والحسن بن عثمان التملي، وعيسى السكتاني، وأبو محمد عبد الله بن يعقوب السملالي، وعبد العزيز الرسموكي، وعلي بن أبي بكر المنتاكي، وعمر بن عبد العزيز الـكـرسيفي، وأبو زيد الفاسي وغيرهم. وأما القول بتحديد قدرها في النصف فمجرد دعوى تحتاج إلى دليل وإثبات ببرهان.
وبعد عام سعيها يحيق *** في أشريات أخذها يليق.
فالسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ههنا هو: لماذا يرفع من شأن ابن عرضون في قضية واحدة فقط، ويشاد بأقواله فيها، وينظر إليها على أنها اجتهاد عميق ودقيق، في حين تتجاهل عن كل آرائه وأقواله في المسائل الأسرية الأخرى وغيرها؟
إن هذا التعامل الانتقائي مع أقوال الرجل وفتاواه ما هو إلا تحايل على الحقائق، وعبث بمفردات المعرفة، وتنكب عن قواعد العلم الصحيح.
لقد تبين مما سلف ذكره بأن ابن عرضون لا يُقدّم اليوم للناس على أساس أنه علم من الأعلام الذين خدموا المذهب المالكي، وأسهموا فيه تنظيرا وتنزيلا، وإنما يستثمر اسمه في الترويج لقضية واحدة فقط؛ هي حق الزوجة في الكد والسعاية، علما بأن هذا الذي ينسب للرجل غير مسلم؛ سواء من حيث ثبوته أو من حيث أسسه وأصوله. ولذلك حق لكل مشتغل اليوم بتراث أبي العباس أحمد ابن عرضون أن يزيد في سيرته هذا الوسم: “الفقيه ابن عرضون المفترى عليه”.




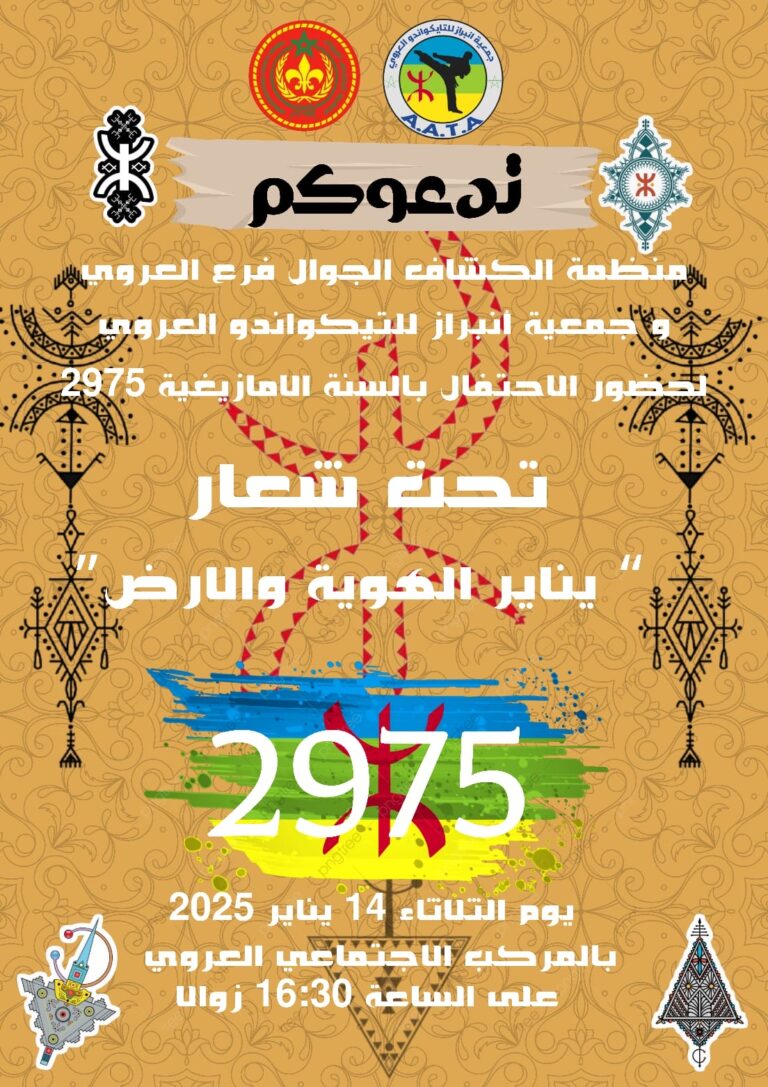












2 Comments
تحليل وتفسير دقيقتين من استاذنا حفظه الله
دقيقين